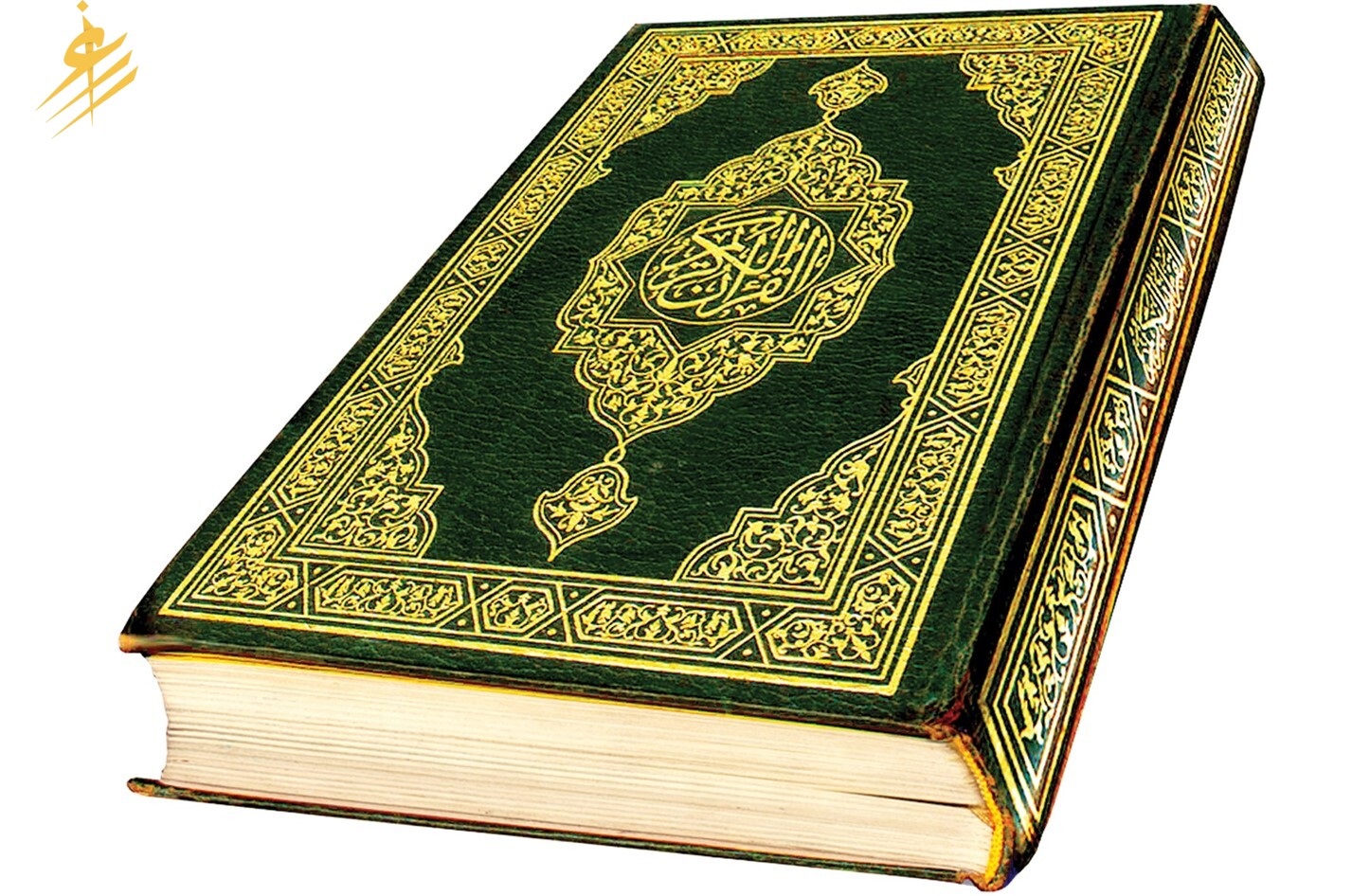تشمل بلاغة القرآن الكثير من الألفاظ الشاملة والجامعة التي سعي العرب لمعرفتها وتفسيرها، ومن هنا سونضح بعض المعاني والتفسيرات المختلفة.
أشهر أمثلة على بلاغة القرآن
- ومن عجائب القرآن اختيار اللفظة المعينة التي لا يمكن أن يقوم غيرها مقامها، كما لو تأملت في قوله تعالى: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ [سورة التوبة:32].
- لماذا استعمل “يطفئ” ولم يستعمل مثلاً “يخمد” وكلاهما يستعمل في النار، لكن العرب تفرق بين الإطفاء والإخماد.
اقرأ المزيد عن: أول من أسلم من الصحابة.
إليك بعض من أمثلة على البلاغة في القرآن الكريم كالتالي:
- العرب تستعمل كليهما في النار.
- العرب تفرق بين الإطفاء والإخماد مع أن كليهما مستخدم في النار من جهة أن الإطفاء يستعمل في القليل والكثير والإخماد يستعمل في الكثير فقط.
- فإذن، ما يمكن قوله شبّت نار في علبة المناديل أخمدناها، لا تأتي، عند العرب الإخماد في النار الكبير.
- وتأمل قول الله: امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ.
- هذه العبارة جاءت للتشنيع على امرأة العزيز، وقوله “امرأة” فيه تشنيع باعتبار الوضع العائلي، امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ فيها تشنيع.
- النسوة في المدينة قالوها وقد استبشعوا واستشنعوا ما فعلته امرأة العزيز، ومثل هذه المرأة بالتأكيد لها أعداء وحساد على مكانتها.
- فلا شك أن العبارة عبارة تشنيع على امرأة العزيز، لكن وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ [سورة يوسف:30].
- تأمل الآن اختيار الألفاظ للدلالة على التشنيع، ما قالوا: فلانة، ولا زليخة تراود فتاها عن نفسه، لا، امْرَأَتُ الْعَزِيزِ فكلمة امرأة تدل على التشنيع من جهة الحالة العائلة، إن هذه المرأة متزوجة، ثم تفعل بهذا الفعل؟ يعني لم تكتفِ بزوجها ومدّت نفسها وعينها إلى الحرام.
أشهر أمثلة على بلاغة القرآن
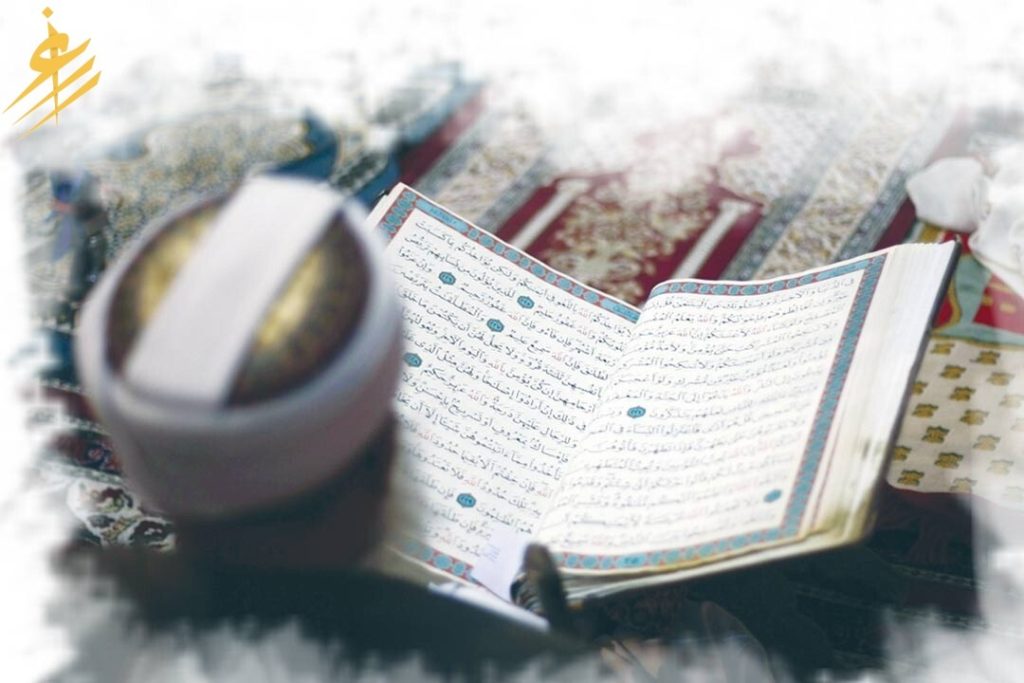
القرآن الكريم يعتبر مصدرًا هامًا للبلاغة العربية، ويتميز بأسلوبه الرائع واستخدامه للعديد من الأساليب البلاغية، إليك بعض الأمثلة على بلاغة القرآن:
- التشبيه (المجاز):
قوله تعالى في وصف الله: “اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ” (النور: 35)
في هذا المثال، يستخدم القرآن التشبيه ليصف الله بأنه نور السماوات والأرض، ليعبر عن نقاء وسطوع الله كنور. - الاستعارة (المجاز المرسل):
قوله تعالى: “وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ” (الشعراء: 80)
يُظهر هنا الله كشافي الأمراض، وليس بطبيب عادي، بل يستخدم القرآن الاستعارة للتأكيد على قدرته على الشفاء. - التخطيط والتنظيم:
ترتيب الآيات في القرآن يعكس تنظيمًا رائعًا، حيث يبدأ بآيات تتحدث عن التوحيد والربوبية، ثم ينتقل إلى الأحكام والوصايا، ويتخذ نهاية كتب القرآن المدنية والنبوية. - استخدام الرموز والأمثلة:
قوله تعالى: “إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ” (يونس: 24)
يستخدم القرآن الرموز والأمثلة، مثل مثل الحياة الدنيا كالماء الذي يروي النباتات ولكنه يزول، ليصف زخرفة الدنيا وتحذيرها من الاعتماد الكامل عليها.
هذه أمثلة قليلة على بلاغة القرآن الكريم، وهناك العديد من الأمثلة الأخرى التي تظهر الجمال اللغوي والفصاحة في أسلوب القرآن.